موسوعةالأخلاق الإسلامية-ظواهر خلقية لأكثر من أساسٍ خلقي( أمثلة في الشجاعة الإيمانية)
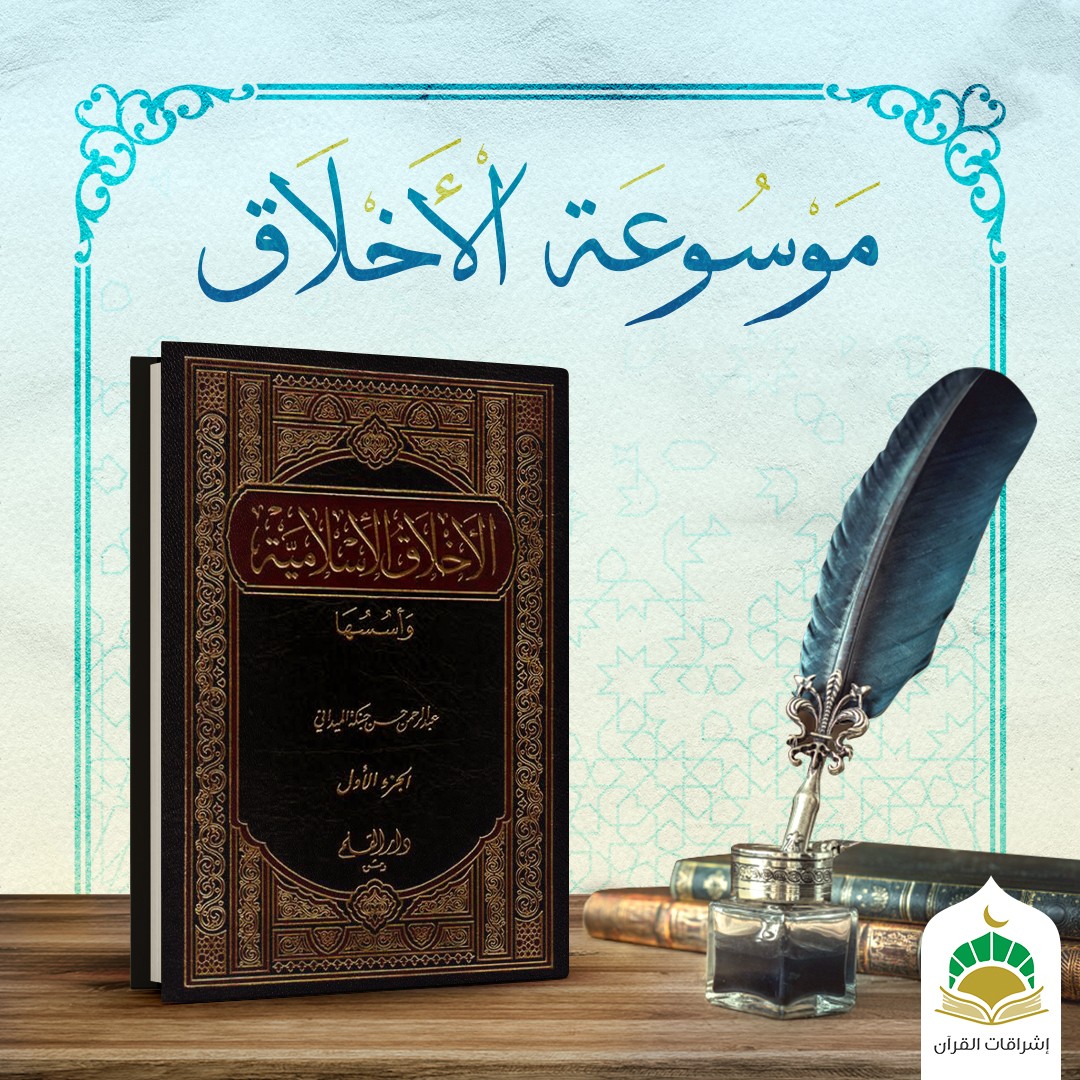
الوصف
ظواهر خلقية لأكثر من أساسٍ خلقي
أمثلة في الشجاعة الإيمانية
الباب الرابع : جوامع مفردات الأخلاق وكلياتها الكبرى >> الفصل العاشر: ظواهر خلقية لأكثر من أساسٍ خلقي >>
أمثلة في الشجاعة الإيمانية:
المثال الأول:
روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
في الجنة
فألقى تمرات كن في يده، ثم قاتل حتى قتل.
يتبين لنا من قصة هذا الحديث، أن الإيمان بما بعد الموت كما جاء في العقيدة الإسلامية يشحن قلوب المؤمنين بشجاعة نادرة، تدفع بالمؤمن إلى ساحة الموت بانطلاق عجيب ينقطع فيه عن الدنيا وما فيها، تعلقًا بالنعيم المقيم الذي يناديه من الآخرة، وشوقًا إلى ما في الجنة من كرامةٍ ورضوان من الله.
ولذلك لما سأل هذا الصحابي عن مكانه بعد الموت إذا هو قتل في سبيل الله، وأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن مكانه في الجنة، توقدت في قلبه نيران الشوق إلى لقاء ربه، فلم يصبر مدة يسيرة يأكل فيها تمرات معدودات كانت في يده مع ما يشعر به من جوع، بل ألقى بها واندفع بشجاعة نادرة يبتغي الشهادة في سبيل الله، وما زال يقاتل قتال المستميت حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه.
ومن هذا نستدل على أن من أساليب تربية قلوب المؤمنين على خلق الشجاعة أسلوب غرس اليقين بما أعده الله من كرامة ونعيم مقيم في الجنة، للذين يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون، وذلك لما في هذا الأسلوب من تحويل مطامع الأنفس إلى ما هو أجلّ من الدنيا وما فيها، وعندئذٍ يغدو الحرص على الدنيا في مرتبة منخفضة جدًّا بالنسبة إلى الحرص على الآخرة وما فيها من أجر عظيم وثواب جزيل.
وهذا التحويل النفسي عن طريق الإيمان بما هو أعظم من كل ما تتعلق به الأنفس من الدنيا، ينبغي أن يكون في المرتبة الأولى من الإصلاح التربوي، سواء أكان ذلك في ميدان الأخلاق أو في الميادين التربوية الأخرى.
ولذلك عمل الإسلام على غرس الإيمان أولًا، ثم انتقل إلى بيان التعاليم الإسلامية الأخرى والتربية عليها، ومنها الفضائل الأخلاقية.
المثال الثاني:
وروى البخاري ومسلم عن أنس قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء -يعني أصحابه الذين تركوا مواقعهم في أحد- وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء -يعني المشركين-.
ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد، فقال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع.
قال أنس: فوجدنا به بضعًا وثمانين ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثّل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه.
قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه:
(مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً (23)) سورة الأحزاب (33). ![]()
في هذا الحديث قصة من قصص بطولات أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أنس بن النضر رضي الله عنه أثبت في أحد أنه يتحلى بخلقين عظيمين من أخلاق الإيمان:
الأول:
شجاعته النادرة حتى الشهادة، مع الصبر على آلام القرح، والاستهانة بالحياة الدنيا، طلبًا لرضوان الله والجنة.
الثاني:
وفاؤه التام بما عاهد الله عليه، إذ قال: ليرين الله ما أصنع. فوفى، فقاتل قتالًا شديدًا صادقًا، وضحى تضحيات لم يبذل مثلها عظماء الأبطال.
وكان ما قدمه رضوان الله عليه مظهرًا من مظاهر إيمانه القوي الذي ملأ أبعاد فكره وقلبه ونفسه.
ليرين الله ما أصنع: رويت بوجهين: الأول بضم الياء وكسر الراء، والثاني بفتح الياء والراء. والمعنى على الوجه الأول: ليظهرن الله للناس ما أصنع من جهاد صادق في سبيله، والمعنى على الوجه الثاني: أن الله تعالى سيرى ما يصنع. وقد أقسم رضوان الله عليه على عهده هذا، فاللام واقعة في جواب قسم محذوف.
وقد صدق أنس بن النضر ما عاهد الله عليه، ووفى به أحسن الوفاء، رغم أن الأمر يتعلق بالجود بالنفس.
قوله: "اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء" يعني به أصحابه الذين أغراهم الطمع بالغنائم فتركوا مواقعهم، وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان عملهم سببًا في تحول رياح النصر عن المسلمين إلى المشركين.
فمنهم من قضى نحبه: يطلق النحب في اللغة على النذر، وعلى الموت، وعلى الحاجة، وعلى الأجل والمدة، وكل هذه المعاني صالحة لأن تفهم من الآية، والأول منها أقرب لسياق معنى الآية ولمناسبتها بوجه عام. والله أعلم.
المثال الثالث:
روى مسلم عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفًا يوم أحد فقال:
من يأخذ هذا مني؟.
فبسطوا أيديهم كل إنسان يقول: أنا أنا.
فقال:
فمن يأخذه بحقه؟.
فأحجم القوم، فقال أبو دجانة (سماك بن خرشة رضي الله عنه): أنا آخذه بحقه، فأخذه ففلق به هام المشركين.
يلاحظ أن عرض الرسول صلى الله عليه وسلم السيف على أصحابه بالشكل الذي عرضه في يوم معركةٍ ذات شأن، يتضمن إثارة روح المنافسة الكريمة بينهم، لغرس خلق علو الهمة في نفوسهم، والتحمس لطلب المعالي، واكتشاف الشجعان الأبطال فيهم.
لقد امتحنهم في طريقة العرض التي استخدمها مرتين:
الأولى:
امتحنهم بها في مجال الطمع بالحصول على تكريم خاص منه صلوات الله عليه وسلامه، فاستشرفت نفوسهم جميعًا لذلك، وانطلق كل واحد منهم يقول: أنا أنا. إذ كان عرضًا لعطاء خالٍ من مسؤولية مرافقة له، فرغب كل واحدٍ منهم في أن يكون هو الظافر به.
الثانية:
كان العرض فيها مقترنًا بالمسؤولية المقصودة من العطاء، عندئذ عرف الصحابة أن من يأخذ السيف لا بد أن يعطي مع أخذه له وعدًا أو عهدًا يلتزم بتنفيذه تجاه الله والرسول، وذلك بأن يبلي فيه بلاءً حسنًا في القتال.
وهذا ما جعلهم يحجمون، ويفكرون بالأمر الذي سيعطون عليه العهد، إذا هم وافقوا على أخذ السيف من الرسول بحقه.
وهنا نجد أن واحدًا منهم قد وزن نفسه وزنًا صحيحًا، وأحس من نفسه أنه على استعداد لأن يفي بعهده ووعده، ويقاتل أعداء الله بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال المستميت، حتى ينكسر السيف أو يستشهد. فقال أبو دجانة: أنا آخذه بحقه، فأعطاه الرسول السيف، فأخذه فوفى بحقه تمامًا، فقاتل به وأبلى بلاءً حسنًا، وأثبت أنه وفيّ بوعده، شجاع مقدام، وضرب في الجهاد في سبيل الله مثلًا رائعًا دل على شجاعته وبسالته وصدقه، كما تذكر كتب السيرة النبوية.
ولا نشك في أن عددًا وفيرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة قد كان قادرًا على أن يأخذ سيف رسول الله بحقه، ولكن مسؤولية الوعد والعهد كانت مسؤولية كبيرة في نفوسهم، جعلتهم يتريثون حتى يزنوا أنفسهم وزنًا صحيحًا، وهذا يدل على أنهم كانوا يتحلون بأخلاق عظيمة تجعلهم لا يعطون الوعد حتى يكونوا عازمين على الوفاء به، وحتى يأنسوا من أنفسهم القدرة على ذلك، وهذا من أثر التربية الإسلامية التي رباهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغرستها في قرارة نفوسهم تعاليم القرآن الكريم.